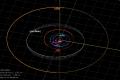سلطان بن محمد القاسمي
لا يمكن لأي مؤسسة، مهما كان حجمها أو طبيعة عملها، أن تستمر وتحقق أهدافها دون جمهور داخلي يمثل القلب النابض لها، وهذا الجمهور هو موظفوها الذين يبذلون جهدهم ووقتهم وخبراتهم في سبيل دفع عجلة الإنجاز.
هؤلاء ليسوا مجرد أرقام في سجلات الحضور والانصراف، بل هم الأساس الذي تبنى عليه سمعة المؤسسة، وهم المرآة الحقيقية التي تعكس صورتها أمام المجتمع والجمهور الخارجي. غير أن ما يدعو للتأمل أن المؤسسات تتفاوت في طريقة تعاملها مع موظفيها، حتى تكاد تشكل ثلاثة أنماط متباينة.
النمط الأول هو المؤسسة التي لا ترى في موظفيها سوى أوقات الحضور والغياب، فهي لا تعلم عن حياتهم شيئا، ولا تهتم بظروفهم، ولا تتذكرهم إلا حين يتغيبون. هذه المؤسسة تختزل قيمة الإنسان في بطاقة توقيع أو جهاز بصمة، وتتجاهل أن الموظف ليس آلة ميكانيكية؛ بل كيان بشري له مشاعر وآمال وتحديات. إن مثل هذه المؤسسات لا تدرك أن هذا التجاهل يقود تدريجيًا إلى فتور الحماس وانخفاض الإنتاجية، فالموظف الذي لا يُقدَّر يتحول مع الوقت إلى عنصر غائب رغم حضوره الجسدي.
أما النمط الثاني فهو المؤسسة التي تتعامل مع موظفيها كما لو كانوا جنودًا في معسكر تدريب دائم، تراقب كل حركة وتترصد كل هفوة، وتحيطهم بعيون تترصد أخطاءهم أكثر مما تتابع إنجازاتهم. الموظف هنا يعيش تحت ضغط نفسي هائل، مشدودًا بين واجباته المهنية والخوف من الوقوع في خطأ أو لفظ كلمة قد تُفسر ضده. هذه الأجواء تقتل روح الإبداع والمبادرة، وتحول الموظف إلى منفذٍ ميكانيكي للتعليمات، يخشى أن يفكر خارج الصندوق أو يجرب حلولا جديدة.
أما النمط الثالث- وهو الأقل وجودًا- فهو المؤسسة التي تنظر إلى موظفيها كجمهور يستحق التقدير والاهتمام، وتتعامل معهم على أنهم رأس المال الحقيقي وكنزها الثمين. هذه المؤسسة تسعى لتطوير موظفيها، وتحرص على تأهيلهم، وتراعي ظروفهم الإنسانية والاجتماعية، لأنها تدرك أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر ربحية على المدى الطويل. فهي لا ترى في الموظف مجرد أداة للإنتاج، بل شريكا في اتخاذ القرار ومساهمًا في رسم مستقبل المؤسسة.
ومن المؤسف أن أغلب المؤسسات لا تلتفت إلى هذا الكنز الذي بين يديها، فهي تسخر مواردها لشراء أحدث الأجهزة وتطوير أنظمتها التقنية، لكنها تتردد في بذل جزء يسير من الجهد أو المال لرفع مستوى موظفيها، أو تحفيزهم على الإبداع، أو حتى الإصغاء إلى مقترحاتهم. بينما الحقيقة أن المؤسسة، مهما بلغت تقنيتها وتجهيزاتها، لن تنجح إن كان موظفوها محبطين أو فاقدي الحماس.
إن الاستثمار الحقيقي للمؤسسة يجب أن يكون في موظفيها: في عقولهم قبل أيديهم، في أرواحهم قبل جداول أعمالهم. فحين يشعر الموظف أنه شريك في تطوير المؤسسة، وأن صوته مسموع ورأيه معتبر، فإنه يمنحها ولاءه الكامل ويضاعف من جهده. عندها يتحول إلى إضافة نوعية، لا إلى عبء يشغل المؤسسة بمراقبة حضوره وغيابه.
الجمهور الداخلي هو الرقم الأهم في معادلة النجاح. وهو المحور الذي تركز عليه إدارات العلاقات العامة الحديثة في المؤسسات العالمية؛ إذ لم يعد دوره يقتصر على تنفيذ المهام اليومية، بل أصبح جزءًا أصيلاً من صناعة القرار، والتخطيط الاستراتيجي، وتنفيذ البرامج. الموظف هو الذي يقدم زهرة عمره وطاقته وخبرته، فهل يعقل أن يُعامل وكأنه طرف ثانوي في معادلة الإنجاز؟
ومما يزيد المشهد تعقيدًا أن بعض المؤسسات لا تحسن التمييز بين الموظف الذي يبذل جهدا مضاعفا، ويسهر الليالي مدفوعا بالشعور بالمسؤولية، فينجز في يوم ما قد يعجز غيره عن إنجازه في أسبوع، وبين الموظف العادي الذي يقتصر عطاؤه على أداء ما هو مطلوب منه في ساعات الدوام فقط، دون زيادة أو مبادرة. والمفارقة المؤلمة أن هذا الموظف العادي قد يكون هو من ينال التكريم والتحفيز والميزات، بينما يُهمَّش الموظف المجتهد الذي يعطي المؤسسة من وقته وجهده وحتى من أيام إجازته الخاصة. وهنا تختل المعايير، ويضعف الحافز، ويفقد المجتهد شغفه حين يرى أن الجهد الإضافي لا يقابله تقدير عادل. والمؤسسة التي تسقط في هذا الفخ لا تدرك أنها تخسر طاقاتها الذهبية بأيديها، لأن العطاء لا يستمر طويلًا إذا غاب الإنصاف.
ولكي تحقق المؤسسة إنتاجًا أكبر وأداء أرقى، فإن عليها أن تبني بيئة عمل تحترم موظفيها، وتجعلهم فخورين بالانتماء إليها. بيئة توفر لهم الاحترام، وتصغي لآرائهم، وتفتح أمامهم أبواب المساعدة والتقدير، وتمنحهم الفرصة لتقديم النقد البناء والاقتراحات التطويرية. ومن المهم أيضا أن يكون الموظف على اطلاع دائم بأهداف المؤسسة الكبرى، ليشعر أنه جزء من رؤية واضحة، وليس مجرد ترس صغير في آلة ضخمة.
ولا ينبغي أن نغفل عن الجوانب الإنسانية في حياة الموظف، فهي لا تنفصل عن حياته العملية. فالمؤسسة التي تراعي ظروف موظفيها الاجتماعية، وتمنحهم فترات راحة مناسبة، وتدعمهم بالبرامج التدريبية والتأهيلية، وتزيل العقبات التي تعترض إبداعهم، إنما ترسخ لديهم شعورًا بالانتماء والوفاء. وعندما تزرع المؤسسة الثقة والطمأنينة في نفوس موظفيها، فإنها تحصد مضاعفة في الولاء والإنتاجية والالتزام.
إن المؤسسات الناجحة التي تسعى إلى بلوغ قمم التميز لا تجعل موظفيها آخر من يعلم أو آخر من يُسأل أو آخر من يُشكر، بل تجعلهم شركاء في الإنجاز وحاضرين في جلسات التخطيط والعصف الذهني. هذه المؤسسات تدرك أن نجاحها ليس صدفة، وإنما هو حصيلة عمل جماعي متكامل، يقوده موظفون يشعرون بأنهم العمود الفقري لها. ومن هنا يتحقق الصعود السوي والواثق، نحو قمة يظل فيها العنصر البشري هو الحزام الذي لا ينفك، والعضد الذي لا يترك.
أما المؤسسات التي تهمل موظفيها، وتغفل عن تقديرهم، وتتعامل معهم بسطحية أو استعلاء، فإنها تكتب بيدها شهادة تراجعها، حتى وإن كانت تمتلك أحدث الأنظمة. لأن النجاح لا تصنعه الأجهزة ولا البنى التحتية وحدها، بل يصنعه الإنسان حين يجد مناخًا مشجعًا ومحفزا، فيفيض عطاء لا ينضب.
ولهذا، فإنَّ أكبر خطأ ترتكبه أي مؤسسة هو أن تختزل موظفيها في خانة الحضور والغياب. فالحضور الحقيقي لا يُقاس بالبصمة أو التوقيع، وإنما يُقاس بمدى حضور الروح والعقل والإبداع في بيئة العمل. وإن غاب هذا الحضور فلن تنفع تقارير الأداء، ولن تجدي الخطط، لأن المؤسسة عندها تكون قد خسرت أهم ما تملك: جمهورها الداخلي.